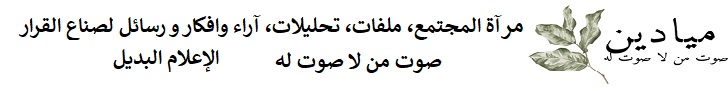في تلك الأرض المتعبة، القسوة صامتة، متقنة، تعرف كيف تعمل في الظل، كيف تختبئ خلف وجوه الأمهات، خلف تجاعيد الخيام، وخلف الانكسارات الكبرى. هنا، في أطراف دارفور، لا تختطف الطفولة في مشهد واحد صاخب، إنما تسحب ببطء، كما يسحب الهواء من رئة تتعب ولا تصرخ
الأمهات هنا تجاوزن مرحلة الصراخ. الصراخ كان في البداية، حين كان هناك أمل بأن الصوت قد يعيد الغائب. الآن، ما نراه هو ما بعد الصدمة، ما بعد السؤال، ما بعد الطرق على الأبواب التي لا تفتح. عيون تحدّق في الفراغ لأن النظر إلى الواقع صار أثقل من الاحتمال. كأن الزمن توقّف عند لحظة محددة.. لحظة اختفاء طفل
تتحدّث إحداهن عن أبنائها الثلاثة، لا ترفع صوتها، ولا تبكي. تعدّ الأعمار بهدوء جارح، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر. الأرقام هنا ليست معلومات، إنما شقوق في القلب. كل رقم يعني سنة لن تعود، ضحكة انقطعت، وسريراً صار فارغا، من دون أن يسأل عنه أحد
شهادات تقال ولا تتابع، قصص تسمع ثم تترك معلّقة، وأطفال يختفون في المسافة الرمادية. تلك المسافة هي أخطر الأمكنة، لأنها تمنح الجريمة وقتاً إضافياً لتتجذّر، ولأنها تتيح للعالم أن يتذرّع بالانتظار
النساء يحملن من تبقى من أطفالهن بأجسادهن كلها، لا بأذرعهن فقط. في كل حركة حذر، في كل التفاتة خوف مكتوم. الأمومة هنا لم تعد رعاية فقط، صارت حراسة دائمة، حالة تأهب لا تنام. في عالم صار فيه الاختفاء احتمالاً يومياً، يتحول الحضن إلى درع، والاقتراب إلى ضرورة. الأطفال الذين لم يختطفوا بعد، يعرفون أكثر مما ينبغي. يعرفون أن اللعب ليس مضموناً، وأن العودة ليست دائماً مؤكدة، وأن الاسم قد يمحى بسهولة إذا لم يكن هناك من يردّده بصوت عال. الطفولة هنا قصيرة، لا لأن العمر قصير، إنما لأن الخوف يسرّع كل شيء. ما يحدث ليس حادثة منفصلة، ولا خطأ عابراً في سياق فوضوي. هو نمط. اختطاف الأطفال، الاتجار بهم، استعبادهم، أو محو هوياتهم بالكامل. الجرائم هنا لا تحتاج إلى ضجيج، تحتاج فقط إلى صمت كاف، وإلى عالم مرهق من المتابعة، يفضل التسميات العامة على المواجهة الصريحة
اللافت أن الشهادات تتشابه، رغم اختلاف الوجوه. التفاصيل تتكرر، كأن الحكاية واحدة تروى بأصوات متعددة. هذا التشابه يرسخ الحقيقة. فالجرح واحد، مهما تغيرت الأسماء
الحديث عن هؤلاء لا يطلب شفقة، ولا يسعى إلى تعاطف سريع ينتهي بانتهاء النص. ما يطلب هو الذاكرة. ألا نمر على هذه الحكايات كما نمر على خبر عابر، ألا نختصرها بعبارة «مأساة إنسانية» ثم نكمل يومنا. لأن الطفل الذي اختفى في دارفور لا يقل غياباً عن طفل نعرف اسمه، ولا تقل حياته قيمة لأنه ولد في مكان اعتاد العالم أن يخذله
الكتابة هنا ليست فعل تضامن فقط، هي مقاومة للنسيان. محاولة أخيرة لنقول رأيناكم، سمعناكم، ونعرف أن الغياب ليس قدراً طبيعياً. أن نكتب يعني أن نرفض تعليق القصص في الهواء، وأن نصر على أن يكون لها وزن، وصوت، وأثر
لا نهاية واضحة لهذه الحكايات. وهذا ما يجعلها أكثر ألماً. الأطفال ما زالوا غائبين، الأمهات ما زلن ينتظرن، والعالم ما زال يملك خياراً واحداً، يملك خياراً لم يستخدمه بما يكفي، أن ينظر طويلاً، وأن يتحمّل مسؤولية ما يعرف
مفاتيح بلا أبواب
في ترقوميا، لا يبدأ الهدم من الجدار، بل من الفكرة
الفكرة التي تقول إن هذا البيت لم يكن يوماً بيتاً، وإن هذا المفتاح مجرد قطعة حديد، وإن الذاكرة تفصيل يمكن شطبه بجرافة
في ترقوميا، يقف الرجل أمام منزله كما يقف المرء أمام جسده حين ينتزع منه عضو حيّ وهو ما زال يتنفس
المشهد لا يحتاج تعليقاً. رجل مسن، رأسه أصلع من شدة ما شهد وانحنى للسنين، يجلس على كرسي بلاستيكي أمام بيته الذي يسحب من تحته، يبكي لأن المكان الذي كان يخبئ فيه صوته، صلاته، تعب زوجته، وضحكات أولاده، صار فجأة «مخالفة بناء». يبكي لأن القانون قرّر أن يكون أعلى من الإنسان
في الصور، يتعانق رجلان. أحدهما يبكي، والآخر يحاول أن يكون جداراً بديلاً. في هذا العناق، تختصر فلسطين كلها… شعب يربّت على نفسه لأن العالم لا يملك الوقت لذلك
الضفة الغربية من الأعلى، بيوت فلسطينية متلاصقة كقلوب خائفة، وخلفها مستوطنات بيضاء، مرتبة، صامتة. هنا يتضح الهدف، ليس الهدم صدفة، وليس التوقيت بريئاً، وليس الرقم تفصيلاً. ألف وأربعمئة مبنى هدمت. الرقم ليس إحصاء، بل عدد البيوت التي نامت فيها العائلات ليلة واستيقظت بلا سقف
والجرافة ما زالت لا تتقن سوى لغة واحدة، التقدّم إلى الأمام. لا تعرف معنى «بيت»، ولا تفرّق بين غرفة طفل ومخزن
ثم تظهر النساء. هنا يتغير الإيقاع. امرأة تسحب من ذراعها فتصرخ بأعلى صوتها. امرأة أخرى تمسك بها جارة، كأن الأجساد وحدها صارت وطناً متنقلاً. في هذه اللحظة، نفهم أن التهجير لا يعني فقدان المأوى فقط. يعني اقتلاع الجسد من عاداته، من طريقه اليومي، من الرصيف الذي حفظ خطواته
وفي زاوية أخرى، شاب ملقى على الأرض. الجنود يقفون حوله كأنه قطعة أثاث زائدة عن الحاجة. الأرض هنا ليست حيادية، الأرض منحازة للجسد الملقى عليها، تضمه وتكاد تبكي من قهرها عليه
أما عن ارتجافة اليد حين يطلب من صاحب البيت أن يهدم بيته بيده، فكل الكلمات تسقط أمام تلك اللحظة، كيف نروي تلك اللحظة التي يجبر فيها الإنسان على أن يكون جلاد ذاكرته
في بيت آخر، طفل يحمل مطرقة، لأن الاحتلال قرر أن يعلمه باكراً معنى المشاركة في الخسارة. المطرقة أكبر من يده، والضربة أكبر من عمر. هكذا يصنع المنفى داخل البيت!
بعد بدء الإبادة في غزة، اتسعت الشهية. كأن الدم فتح باباً إضافياً للهدم في الضفة. كأن الجرافة شعرت أن العالم مشغول بما يكفي. الجنود يتحرّكون بثقة لأنهم يعرفون بأن الكاميرا ستغلق بعد قليل، وأن الخبر سيزاحمه خبر آخر
لكن ما لا تلتقطه الكاميرا هو ما يبقى. يبقى المفتاح في الجيب، حتى بعد أن يختفي الباب. تبقى المرأة تعرف نفسها باسم القرية، لا بعنوان الشارع. يبقى الرجل يعد غرف البيت الذي لم يعد موجوداً، كأن العد طقس مقاومة
الهدم لا يعني فقدان المأوى فقط. يعني محاولة محو العلاقة بين الإنسان والمكان. محاولة إقناع الفلسطيني أنه ضيف ثقيل على ذاكرته. ومع ذلك، تفشل المحاولة كل مرة، لأن البيت، في فلسطين، ليس جداراً، البيت فكرة، والفكرة لا تهدم
مريم مشتاوي – كاتبة لبنانية




 World Opinion | Alternative Média زوايا ميادين | صوت من لا صوت له Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média
World Opinion | Alternative Média زوايا ميادين | صوت من لا صوت له Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média